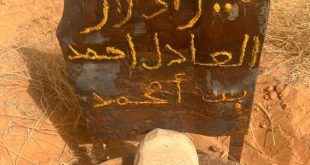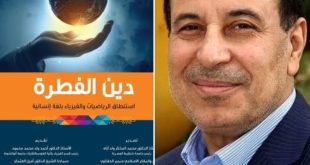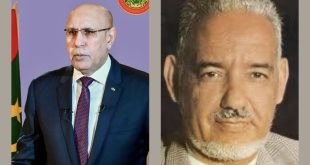تحتلّ إمارة آدرار موقعًا محوريًا في التاريخ السياسي والاجتماعي والعسكري لموريتانيا، غير أنّ التوثيق المتعلق بها ظلّ محدودًا ومتأثرًا—في مجمله—بالرواية الاستعمارية الفرنسية، التي ركّزت على الأبعاد الإدارية والعسكرية للمشهد، متجاهلة البنى الاجتماعية، شبكات التعليم التقليدي، دور الطرق الصوفية، وحركة المقاومة الشعبية.
ويظهر هذا القصور بوضوح عند تناول واحدة من أهم محطات المقاومة الوطنية: عملية القضاء على المندوب الفرنسي كبولاني في تجكجة سنة 1905م، التي قادها الشريف سيدي ولد مولاي الزين، والتي شكلت منعطفًا حاسمًا في مشروع التوسع الفرنسي. فقد قال الجنرال كورو:
“أشرس مقاومة وجدناها في غرب إفريقيا كانت في آدرار.”
وبما أنّ موضوع إمارة آدرار والمقاومة المرتبطة بها يُعدّ من المجالات شحيحة المصادر، فقد اعتمدت هذه الدراسة—كما هو دأبي في أبحاثي السابقة—على اجتهاد شخصي مستند إلى الروايات الشفوية المحلية، مرفقة بتحليلات نقدية للروايات الفرنسية التي غالبًا ما اختزلت الحدث في صورة “فعل فوضوي” نفّذه “نفر من البدو”، متجاهلةً خلفياته الروحية والاجتماعية والسياسية.
ولقد كان من الضروري الذهاب إلى امحيرث، الواقعة على بُعد 67 كلم من أطار، وبالضبط إلى الموقع الذي انطلق منه القائد سيدي ولد مولاي الزين، بغية جمع المعطيات الميدانية والتحقق من الروايات المحلية بما يعزز دقة الدراسة وموثوقيتها.
إشكالية الدراسة وأسئلتها:
كيف استطاع الشريف سيدي ولد مولاي الزين تنفيذ عملية قتل كبولاني رغم الاختلال الهائل في القوة والعتاد بين المقاومة والجيش الفرنسي؟
ما السياق السياسي والاجتماعي لآدرار قبيل العملية؟
ما دور العامل الروحي والصوفي في اتخاذ قرار التنفيذ؟
كيف كان مسار الرحلة التي تجاوزت 320 كلم وصولًا إلى تجكجة؟
من هم المقاتلون الحقيقيون المشاركون في العملية؟
إلى أي مدى تعكس الوثائق الاستعمارية حقيقة ما جرى؟
أولًا: السياق السياسي والاجتماعي عند دخول كبولاني
دخل كبولاني الأراضي الموريتانية بصفته “مفوّضًا عامًا” مكلّفًا بإحكام السيطرة الفرنسية عقب نجاح الحملات في السنغال والساحل، واتخذ من قلعة تجكجة مقرًا لقيادة عملياته. وكانت المنطقة تعيش آنذاك:
1. هشاشة في السلطة الإمارتية وتشتتًا في الولاءات نتيجة الانقسامات الداخلية.
2. تعددًا لمراكز القوة التقليدية وغياب سلطة جامعة.
3. توترًا اجتماعيًا واسعًا إثر التدخل الفرنسي في شؤون القبائل، وتفاقم القمع بعد معركة بَﯖادوم واستشهاد القائد بكار ولد اسويد أحمد.
وفي هذا المناخ ظهرت ضرورة مقاومة مسلحة ذات قيادة تحظى بثقة المجتمع، كان في مقدمتها:
سيدي ولد مولاي الزين، والأمير سيد أحمد ولد أحمد عيده.
ثانيًا: شخصية القائد سيدي ولد مولاي الزين
يمثّل الشريف سيدي ولد مولاي الزين شخصية استثنائية في تاريخ المقاومة الوطنية؛ فهو:
شيخ صوفي من الطريقة الغظفية(*)، متمسّك بقيم الزهد والانضباط.
لا يمتلك نفوذًا قبليًا أو سياسيًا، لكنه يتمتع برأس مال رمزي وروحي واسع في آدرار.
يرى أنّ قتل كبولاني تكليف ديني مؤيَّد برؤيا كان يكررها، مما منح العملية بُعدًا روحيًا عميقًا.
وتفسّر هذه الخصائص قدرته على تحويل مجموعة متفرّقة قليلة العدد إلى قوة ذات مهمة محدّدة رغم غياب الإمكانيات العسكرية.
ثالثًا: إرهاصات التخطيط ودور الطريقة الغظفية
شرع الشريف سيدي في التجوال بين مناطق آدرار داعيًا إلى الجهاد، لكنه واجه:
ضعف التسليح المحلي مقارنة بالأسلحة الفرنسية الحديثة،
تردّد القوى القبلية الكبرى،
اعتقادًا شعبيًا واسعًا باستحالة المهمة.
ولمّا لم يجد دعمًا كافيًا، قرر المضيّ قدمًا مستندًا إلى يقين روحي صلب.
وتوجّه إلى شيخه محمد محمود ولد الشيخ الغزواني في أوجفت، فأيّد خطته ومنحه السيف البتار(الصورة) الذي “يُقتل به رأس الكفر” حسب التعبير المتداول محليًا.
وكان لهذا الحدث أثرٌ بالغ في تعبئة المقاتلين وتثبيت البعد الروحي للعملية.
رابعًا: مسار الرحلة (أكثر من 320 كلم)
انطلق الشريف من امحيرث بعد أن ودّع زوجته بقوله: “وهبت نفسي لله”.
ومرّ بمحطات متتابعة:
اتويليليلت – شاش – الكارة الزرقة – تيمكازين – بطحاء مريام – آغمورت – ثم قطع الحد الفاصل بين آدرار وتكانت إلى أن وصل كيلمس على بعد 20 كلم من تجكجة.
منهج التعبئة:
اعتمد التجنيد على أسلوب مباشر، حيث كان ابن أخيه “شيغالي” يبلّغ الدعوة التالية:
“من أراد الجهاد وقتل كبولاني فليلتحق بنا.”
التحق 3 رجال في البداية،ثم ارتفع العدد تدريجيًا حتى بلغ 20 رجلًا عند الوصول الى الهدف، مع استبعاد من لا يستوفي شروط الجهاد وفق الروايات الشفوية.
وتعكس هذه الطريقة طبيعة المقاومة اللامركزية في المجتمع الموريتاني.
خامسًا: ليلة الهجوم
في كيلمس اجتمع الرجال العشرون، فأخذ عليهم الشريف عهدًا:
ألا يتحركوا إلا عند سماع تكبيره،
وأن اجتماعهم سيكون “كاجتماع يوم القيامة تحت ظلال العرش” (وهي عبارة تتكرر في معظم المصادر الشفوية).
وقد زوّدهم أحد خدم القلعة الفرنسيين بمعلومات دقيقة عن مداخل القلعة ونقاط الحراسة.
سادسًا: اقتحام قلعة تجكجة – 12 مايو 1905م
خطة الهجوم:
قُسّم المقاتلون إلى مجموعتين:
1. مجموعة مع الشريف تقتحم من الباب الشمالي.
2. مجموعة ثانية تهاجم من الباب الشرقي.
تفاصيل الاشتباك:
دخل الشريف مكبّرًا.
باغت الملازم انتفاه وضربه بالسيف.
أصابه الضابط بمسدسه فسقط شهيدًا.
واستشهد معه عدد من رفاقه:
أحمد ولد هنون – الكوري ولد اشويخ – محمد ولد لحويرثي – وغيرهم.
مقتل كبولاني
تولّى القضاء على كبولاني كل من:
سيدي أحمد ولد أعميرة
أحمود ولد أعليه
فأطلق أحمود النار عليه فأرداه قتيلاً، وصعد أعميرة سور القلعة صائحًا:
“كبولاني مات… كبولاني مات!”
وهي الصيحة التي خلدتها الذاكرة الوطنية.
سابعًا: الرد الفرنسي والمحاكمات
اعتقل النقيب فريرجان أربعين رجلًا من تجكجة ظنًا أنهم منفّذو العملية.
سلّم المجاهد الجريح أحمد ولد أبّاه نفسه قائلاً:
“أهل تجكجة لا علاقة لهم… نحن القادمون من آدرار وقائدنا سيدي ولد مولاي الزين.” أُعدم شنقًا في محاكمة صورية. وقُتل أحمد ولد اميلح وهو جريح. ودُفن الشهداء معًا في حفرة واحدة.
ومن المفارقة أنّ فريرجان ذاته سيصبح لاحقًا أحد أهم مصادر الباحثين في تاريخ مقاومة آدرار.
ثامنًا: قائمة الشهداء والجرحى
الشهداء:
سيدي ولد مولاي الزين _أحمد ولد هنون _الكوري ولد اشويخ _ محمد ولد لحويرثي _ أحمد مولود ولد اميلح _أحمد ولد أعميرة (أُعدم لاحقًا).
الجرحى:
السالك ولد الدد – أحمود ولد أعليه – الللّ ولد سيدي – الجاش ولد البطاح – سيدي أحمد ولد أعميرة
تاسعًا: بين الرواية الفرنسية والرواية المحلية
السردية الفرنسية:
صدمة من دقة التنفيذ.
تجاهل تام للعامل الروحي.
التقليل من شأن التنظيم المحلي.
الرواية المحلية:
تكشف عناصر مغيبة:
مركزية الإيمان واليقين.
دور الطرق الصوفية في التعبئة.
تجاوز البُنى القبلية التقليدية.
فشل الفرنسيين في فهم المحظرة، كما صرّح كريستيان لغري في رسالة سرية وصف فيها المحظرة بأنها:
“العقبة الأكبر أمام المشروع الاستعماري.”
عاشرًا: دلالات العملية وضرورات إعادة كتابة التاريخ
لا يمثّل مقتل كبولاني حدثًا عسكريًا معزولًا، بل:
1. محطة تأسيسية في تاريخ المقاومة الوطنية.
2. تجسيد لالتقاء المقاومة المسلحة والمقاومة الثقافية.
3. دليل على قدرة المجتمع على إعادة تنظيم نفسه خارج الهياكل التقليدية.
4. مؤشر على قصور السردية الاستعمارية ومحدودية رؤيتها.
وتبرز ضرورة إعادة كتابة تاريخ موريتانيا اعتمادًا على:
الروايات الشفوية الأصلية،
المحاظر ودفاتر البيوت العلمية،
قراءة نقدية للوثائق الفرنسية،
دمج رموز المقاومة في الدراسات الأكاديمية.
سؤال يتكرر دائما من قتل كبولاني؟
التاريخ لايعترف الا بالقادة حيث يتضح من قراءة المصادر أن قاتل كبولاني هو الشيخ القائد المخطط والمنفذ سيدي ولد مولاي الزين الذي بلغ من العمر عتياً، لم يكن عسكريًا محترفًا.
هذا الشيخ تجول بين كل من يحمل السلاح طالبًا الدعم والمساعدة، وهو أمر كان شبه مستحيل في ظل التفوق الفرنسي من حيث العتاد والتدريب، سواء كميًا أو نوعيًا.
وعندما لم يجد من يقدم له المساعدة، قرر أن يشرع في مهمته بمفرده، متسلحًا بالإيمان والعزيمة، ليشكّل في طريقه الى تجكجة مجموعة من 20 رجلًا فقط، غير مدربين، مزودين بالأسلحة البسيطة مثل الكشام والقرطاس. وعلى الرغم من ذلك، فقد كان القاتل المباشر لكبولاني اثنين من رفاقه كما اسلفنا سابقا رحم الله الجميع.
ختاما: قدّم الشريف سيدي ولد مولاي الزين ورفاقه نموذجًا نقيًا للفداء والإيمان، وأثبتوا أنّ قوة اليقين قد تهزم قوة السلاح.
استشهدوا، لكن أثرهم بقي حاضرًا في الذاكرة الجماعية للدولة الموريتانية.
كما قال الشاعر:
قد مات قومٌ وما ماتت مكارمهم
وعاش قومٌ وهم في الناس أموات
المصادر والمراجع:
(*)الطريقة الغظفية طريقة صوفية تركز في التربية على العمل والإنتاج والتقشف والجَلـَد ،وهي مزيجاً بين الطريقة القادرية والطريقة الشاذلية، أسسها الشيخ محمد الأغظف بن حماه الله بن سالم الداودي المتوفى سنة 1210 هـ،.
General Corou، خطاب عن المقاومة في آدرار، أرشيف الجيش الفرنسي، 1905.
مقابلات مع أحفاد المشاركين، في معركة تجكجة 1905م
روايات محلية وشهادات شفهية؛ المخضرم السالك ولد خوك.
Christian Legry، رسالة سرية عن المحظرة، 1906.
الطريقة الغظفية طريقة صوفية تركز في التربية على العمل والإنتاج والتقشف والجَلـَد ،وهي مزيجاً بين الطريقة القادرية والطريقة الشاذلية، أسسها الشيخ محمد الأغظف بن حماه الله بن سالم الداودي المتوفى سنة 1210 هـ،.
الموكب الثقافي: الجمعية الوطنية للتربية والثقافة والعلوم: العدادان 4.5 مايو 1996م.
صورة سيف القائد المجاهد سيدي ولد مولاي الزين ارسلها لي حفيده الوزير السابق احمد ولد مولاي أحمد
 آفاق فكرية بحث، معرفة، تبادل ثقافي
آفاق فكرية بحث، معرفة، تبادل ثقافي