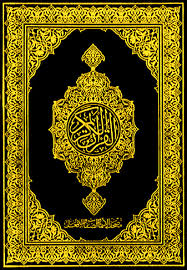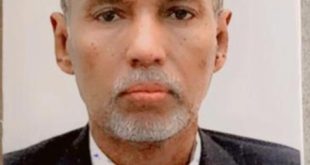في حين نرى الخطاب الإلهي هو الذي ينسب هذا الكلام إلى ذاته بلا منازع بالعودة الى الآيات في الحلقة السابقة بدليل الضمير ﴿ ففتقناهما﴾ ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حي﴾. ومن المعلوم في دنيا العلوم اليوم أن هذا القانون الأخير من أعظم وأوسع وأضخم القوانين الكونية, وهو القائل: إن كلما يتسم بالحياة لا بد أن يكون الماء هو العنصر الأساسي فيه..
وفي الآية الأخرى:﴿ وجعلنا في الأرض رواسي﴾ يتكلم عن صنعته والرواسي هي الجبال. ﴿وجعلنا﴾ ينسب هذا المتكلم هذا الأمر إلى ذاته.(46) والمخاطب هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول:
﴿ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون﴾
﴿ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالخير والشر فتنة والينا ترجعون﴾
يتكلم عن قانون من القوانين الاجتماعية السارية منذ بدأ الخليقة إلى يوم الناس هذا.
﴿ ونبلوكم بالشر والخير فتنة﴾ أي: امتحانا وابتلاء
﴿ وإلينا ترجعون﴾ ولسنا بحاجة بعد هذا إلى بيان مدى تقبل العقل مما يقال بأن القرآن كلام بشر حيث أنه لا يمكن لعاقل أن يتصور أن الذي يقول:
﴿ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون﴾.
﴿ كل نفس ذائقة الموت ﴾ ﴿ ونبلوكم﴾ ينسب هذا إلى نفسه ﴿ بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون﴾.بدليل قوله﴿وإلينا ترجعون﴾؟ لأنه لا يعقل أن يقول الإنسان أن البشرية سترجع إليه؟!
الإنسان الذي خلق قبل سنوات وسيموت غدا فتح عينيه على هذا الكون وطرح الأسئلة منذ نضوجه من أنا؟ ما هذا الكون ؟!! وإلى أين المصير؟!! هل يمكنه أن يقول الكلام السابق، من إبداع الكون، والخليقة؟! والجواب أن العقل لا يمكنه أن يتقبل هذا الإدعاء. وإذا لم يكن هذا الكلام كلام بشر إذن ما المعنى الذي يشع به هذا الكلام؟!
إنه يشع بكمال الربوبية هذه الصفات التي يتحدث عنها هذا النص إنما هي صفات الخالق، المدبر، المكون، قيوم السموات والأرض.
وهذه المعاني التي تنبثق من هذا الكلام هي عبارة عن إشعاع يسري إلى كيان الإنسان أيا كان هذا الإنسان، حتى ولو لم يكن عربيا.
والإنسان عندما يسمع هذا الكلام فلا بد أن يسري إلى نفسيته ما لم يكن متكبرا.
أما إذا كان من المتكبرين فإن هذا الإشعاع المنبثق من الكلام السابق الذكر يصطدم بمشاعر الكبرياء في كيان هذا الإنسان ويرتد له..وهكذا..(47).
ويصف لنا البوطي هذا الصنف من البشر المتكبر من خلال حادثة وقعت في مجتمعه في مجلس عزاء، وهي أن أحد الحاضرين لما سمع تلاوة القرآن، وهو بعد لم يكد يمر على جلوسه دقيقتين، حتى التفت إلى زميله الذي يجلس إلى جانبه وأسر إليه قائلا:
( قم فإن هذا الكلام يكاد يغير عقلي) وخرج هاربا، فما الذي خافه هذا الإنسان على نفسه؟!
لقد تأثر من شعاع الربوبية الذي يسري من هذا الكلام الذي سمعه إلى نفسيته ولقد كاد أن يدخل إلى نفسيته لكن سرعان ما اصطدم بكبريائه.
ومن هنا كان الفصل بين جلال الربوبية, وبين نفسية هذا الإنسان. وكانت النتيجة أن قام هذا الرجل يفر لائذا بكبريائه, من الحقيقة التي يلاحقه بها كتاب الله سبحانه وتعالى.
أي أن القرآن يخاطب العقل الإنساني السليم, لا العقل المتكبر, الذي يعيش في بيئات تشكوا من الفقر الثقافي بكل وجوهه ومستوياته، المائل إلى البساطة في التفكير وإصدار الأحكام القطعية، ورفض كل ما يخالف ما هو عليه، وذالك لأن بيئته، جعلت قدرته على المقارنة محدودة وهذا هو الاستثناء حيث أن الأصل ” أن بني البشر يملكون درجة من العقلانية، وتلك الدرجة متوقفة على نحو جوهري على مدى حيوية الثقافة وغناها وانفتاحها، وقبل ذالك الإطار الذي تشكلت فيه.
إن مما أضر بفهمنا لمسألة نسبة الصواب والخطأ في الأفكار أننا كثيرا ما ننزع الرأي من إطاره البنيوي وبيئته الثقافية والاجتماعية، فيبدو وكأنه يستمد صوابه من ذاته وقدرته على الإقناع ، واقتناع الناس به.
وهذا حرمنا من فهم المرتكزات العميقة له، ومن فهم البرمجة الثقافية التي وفرها المجتمع لصاحبه(كما أسلفنا)(48).وجعله بالتالي أسيرا لها (49) وهذا ما وقع فيه الكثير من المفكرين والباحثين وهو ما حاولنا تفاديه وقد اكتشفنا أن الخطأ الفكري دائما يأتي من بداية البحث الخاطئة.(50) والنتيجة ستكون بطبيعة الحال خاطئة.
من هذا المنطلق لم يعد معقولا ما قاله فرعون موسى عند ما ادعى الربوبية والذي قال عنه القرآن:
{أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى}﴾ النازعات:24.
يوضح لنا البيان الإلهي بعد ذالك كيف أن كلام فرعون جاء بعد ذالك مغموسا بطبيعته البشرية.
حيث يقول تعالى:
{وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى فَأَوْقِدْ لِى يَٰهَٰمَٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّى صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ}.القصص:30
هكذا يقول الله سبحانه وتعالى على لسان فرعون:﴿ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري ﴾. إذن هو يتكلم كإله ثم قال: ﴿ فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا ﴾. إله ولا يجد سبيلا للوصول إلى السماء إلا الطين وأسبابه..
وهذا الفرعون أو أي فرعون آخر, في أي زمان من أي مكان, ينسى أن (بشريته تكذبه) بدليل أنه يدعي أنه إله, ثم يقول لهامان أوقد لي على الطين يعني:﴿ ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين﴾.
وكأن الخطاب الإلهي يبين للبشرية احتياجها إليه. فالإنسان لا يتحرك ساعة إلا ويطلب أشياء لا يدري هل ستتحقق أم لا ؟ يعبر عنها ” بلعل” ” الرجاء”.(51)
نفس الكلام ينسحب على بعض العلميين في القرن العشرين من بينهم العالم البيولوجي هيكل عند ما قال: ” اعطوني هواء, وماء, ومواد كيماوية ووقتا، وأنا أصنع إنسان” .
ويرد عليه العلامة “كريسى موريسون” رئيس المجمع العلمي السابق بالولايات المتحدة الأمريكية متهكما بقوله:
” إن «هيكل» يتجاهل في دعواه الجينات الوراثية، ومسألة الحياة نفسها، فإن أول شيء سيحتاج إليه عند خلق الإنسان هو الذرات التي لا سبيل إلى مشاهدتها ثم سيخلق الجينات أو حملة الاستعدادات الوراثية بعد ترتيب هذه الذرات حتى يعطيها ثوب الحياة(52) ومن الواضح في هذا الكلام احتياج الرجل إلى المادة والأجزاء والوقت..فبالرغم من تقدم الطب في جميع فروعه وبالرغم من إبداعات العلماء في عصرنا والذين يقدمون لنا أجهزة نأخذ بالألباب وتحير العقول فإن خطابهم ما زال مثل خطاب فرعون (موسى) منذ آلاف السنين: الاحتياج و الطلب؟!!
النص يقدم رؤية تأملية عميقة في الخطاب القرآني، حيث يبرز الفرق الجوهري بين كلام الله وكلام البشر، من خلال تحليل لغوي وفلسفي ودلالي.
هناك عدة نقاط رئيسية يمكن استخلاصها:
1. نسبة الفعل إلى الله: الآيات مثل “ففتقناهما”و “وجعلنا من الماء كل شيء حي” تشير إلى أن المتكلم هو الله، ولا يمكن لعاقل أن يتصور أن إنسانًا يدعي مثل هذه الأفعال التي تتعلق بالخلق والتدبير.
2. الاختبار الإلهي للحياة: الآية “ونبلوكم بالخير والشر فتنة” توضح سنة الابتلاء، وهي حقيقة اجتماعية وسنّة كونية لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيها، مما يدل على مصدر القرآن الإلهي الله عز وجل.
3. العقل المتكبر مقابل العقل المنفتح: القرآن يخاطب العقل الإنساني السليم الذي يبحث عن الحقيقة، بينما العقل المتكبر، كما في قصة الرجل الذي هرب من سماع القرآن، يصطدم بكبريائه ويرفض التأمل في الحقيقة.
4. فرعون كمثال للغرور البشري: ادعاء فرعون “أنا ربكم الأعلى” سرعان ما يتناقض مع احتياجه إلى بناء صرح للوصول إلى السماء، مما يدل على هشاشة ادعائه.
5. تشابه الخطاب العلمي المادي مع خطاب فرعون: عندما ادعى عالم مثل “هيكل” أنه يستطيع صنع إنسان إذا توفر له الماء والهواء والمواد الكيميائية والوقت، فإنه نسي أنه لا يملك القدرة على إيجاد الحياة ذاتها، مما يشبه طلب فرعون من هامان بناء الصرح للوصول إلى الله.
تأسيسا على هذا يتضح أن الإنسان، مهما بلغ من العلم، يبقى بحاجة إلى الإيمان بالله.
وهذه الحاجة تتجلى في محاولات بعض العلماء تفسير نشأة الحياة، لكنهم يصطدمون بحقائق لا يمكن تفسيرها بالعلوم التجريبية وحدها.
هذه الفكرة تتقاطع مع الفطرة الإنسانية، حيث يظل الإنسان يبحث عن إجابات لأسئلته الوجودية الكبرى، والتي يجدها في الخطاب الإلهي.
لماذا لايفكر الانسان في طبيعة الإنسان والعقل، وكيف أن بعض العقول ترفض الحقيقة بسبب الكبرياء أو القصور في الفهم، بينما العقول المنفتحة تستطيع استيعاب الرسالة الإلهية والإقرار بوجود الخالق سبحانه.
على الرغم من التقدم العلمي والتقني، لا يزال الإنسان يواجه التحدي الأزلي: الموت والحياة.
فمنذ نشأته، سعى لفهم وجوده وتأمين بقائه، مستخدمًا الفلسفة، والدين، والعلم لإيجاد إجابات!!
ورغم تطور الطب والتكنولوجيا الحيوية ومحاولاته لإطالة العمر، تبقى الحياة زائلة والموت محتومًا.
التحدي الأول: 1_ الموت:؟ ……يتواصل……
 آفاق فكرية بحث، معرفة، تبادل ثقافي
آفاق فكرية بحث، معرفة، تبادل ثقافي