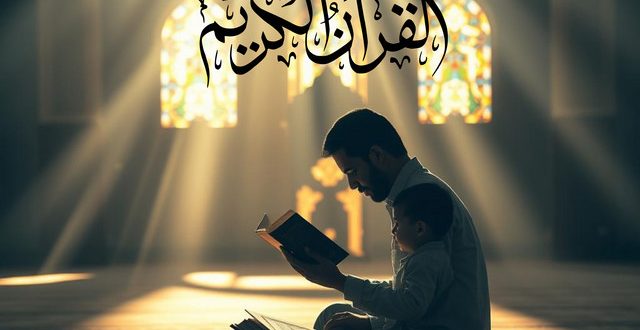بعد رحلة تأملية امتدت عبر حلقات متعددة، حاولنا فيها أن نستكشف كيف يعيد القرآن الكريم تشكيل وعينا، وكيف يُنير لنا دروب الحياة، نصل اليوم إلى المحطة الأخيرة؛ حيث الفطرة، والإيمان، والعلاقة الأصيلة التي تربط القلب والعقل بالله عز وجل.
الدين جزء من الفطرة
منذ بدء الخليقة، والإنسان يشعر بدافع داخلي يدفعه إلى الاستنجاد بمن هو أسمى منه وأقوى وأعظم، مما يدل بوضوح على أن الدين جزء أصيل من فطرته.
حتى العلم يعترف بأن الإنسان يشتاق إلى ما هو أسمى، وأن تقدمه الأخلاقي وشعوره بالواجب ليس إلا ثمرة من ثمار الإيمان بالله والاعتقاد بالخلود.
إن غريزة التدين تكشف عن جوهر الإنسان، وترتقي به تدريجيًا حتى يشعر بالاتصال بخالقه. ودعاؤه الغريزي حين يطلب العون لحظة طبيعية، بل إن أبسط صلاة ترفعه إلى مقام القرب من الله. فالوقار، والكرم، والنبل، والفضيلة، والإلهام، وكل الصفات التي توصف بأنها “إلهية”، لا يمكن أن تنبع من الإلحاد أو الإنكار؛ لأن هذا الأخير مظهر مدهش من مظاهر الكِبر، يضع الإنسان موضع الإله!
وبدون الإيمان تنهار الحضارات، ويضيع النظام، وتنتشر الفوضى، ويسود الشر. لذا، علينا أن نتمسك بإيماننا بوجود الله، ونحافظ على محبتنا له، وإيماننا بالأخوة الإنسانية، فذلك وحده ما يسمو بنا نحوه تعالى.
العقل وحده لا يكفي
بعد أن تعرفنا في الحلقات السابقة على قدرة العقل وطريقته في التفكير، أدركنا أنه لا يستطيع وحده بلوغ معرفة الله، ما لم يصاحبه قلب ينبض بالإيمان والعاطفة، يحرّك تلك المعارف ويحوّلها إلى مشاعر تتغلغل في النفس وتمنحها روعةً وجمالاً.
فالإنسان ليس عقلاً فقط، ولا عاطفة فقط، بل هو مزيج منهما؛ العقل يوجّه، والعاطفة تُحرّك. وهذا هو منطق الفطرة التي فُطر الإنسان عليها.
لقد تتبعنا سويًا الطرق الفكرية المؤدية إلى إدراك هذه الفطرة، ووجدنا أن الغرائز والحاجات العضوية تدفع الإنسان للبحث عمّا يروي عطشه الوجودي، وأن العقلاء لا يجدون صعوبة في رؤية آثار الفطرة من خلال سلوك البشر في شتى أحوالهم.
اللجوء الفطري إلى الله
المريض الذي أعياه الألم، والفقير الذي ضاقت به السبل، والمكروب الذي أظلمت الدنيا في وجهه… جميعهم يرفعون أبصارهم إلى السماء، وتعلو وجوههم رجاء عميق، ولسان حالهم يقول ما يختلج في صدورهم من صدق التعلّق بالمحبوب الأعلى: الله سبحانه وتعالى.
وقد تأملنا هذه المشاعر بدقة، فوجدنا أن أقواها هو الإحساس الفطري بوجود الله، والرغبة في الخضوع له. وهذا ليس أمرًا مكتسبًا، بل هو جبلّة مغروسة في الكيان البشري، تجعل من أبسط نداء إلى الله لحظة قرب وسكينة.
الإسلام… الدين الموافق للفطرة
لقد أدركنا أن الفطرة شيء نحسّه في أعماقنا منذ الولادة، وهي تسبق حتى الحواس في عملها. ومن بين كل الديانات والفلسفات، لم نجد سوى الإسلام هو الذي عرّفنا بهذه الحقيقة وربطها به ربطًا عضويًا، كما في قوله تعالى:
{إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ} [الأعراف: 201]
في هذا النص إشارة إلى أن التذكّر مركوز في فطرتهم، وأن الغفلة ليست أصلاً، بل طارئة بفعل وسوسة الشيطان. وهذا “التذكّر” يشير إلى الخالق المحبوب، وكل ما يقرّب إليه.
فالاهتداء إلى الفطرة نعمة عظيمة تعيد الإنسان إلى سلام داخلي وتناغم مع الوجود كله. ولا يملأ هذا الفراغ الفطري علمٌ ولا فلسفة، بل الإيمان بالله الواحد الأحد فقط.
الفطرة والقرآن الكريم
لقد مثّل القرآن الكريم الفطرة السليمة في معرفة الله ووحدانيته، كما في قوله تعالى:
{وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا} [الأعراف: 172]
فإذا كان الإنسان قد شهد على نفسه بذلك، فكيف يغفل عنه، وفيه غريزة تتوق إليه؟ لقد أضفى القرآن على الذات الإلهية صفات تميزها عن سائر الموجودات، وجعلها في متناول إدراك الإنسان بعقله ووجدانه، كما في قوله:
{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد: 19]
وهو ما يؤكد أن المعرفة بالله لا تكون بالوراثة أو التقليد، بل بالعلم واليقين.
ورفض القرآن التشبيه والتجسيم، ونبّه إلى صفات التنزيه والكمال، كما في سورة الإخلاص:
{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ}
وفي ذلك:
﴿اللَّهُ أَحَدٌ﴾: تنزيه عن الشبيه والنظير.
﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾: كمال الغنى، والملجأ في الحاجات.
﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾: نفي التماثل والمقارنة.
فالله في عقيدة الإسلام هو الموجود الأسمى، المتفرد بكل صفات الكمال، المهيمن على كل ما سواه، ومنه تنبثق الحياة والقوة، وبإرادته تصدر الحركات والتغيرات، كما قال تعالى:
{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]
في مواجهة الإلحاد والكفر.
يتبيّن لنا من خلال ما سبق، بالدليل العقلي والنقلي، أن الإلحاد فقد الأسس التي كان يتكئ عليها، وأضحى مزيجًا من الجهل والعصبية.
إن من يدافعون عنه يعيشون بين الضياع والادعاء، وبين البعد عن الفطرة والغفلة عن الحقيقة.
لقد عشت في هذا البحث فكريًا وقلبيًا وجسديًا، وخرجت منه بإيمان راسخ أن الحقيقة الكبرى في هذا الكون هي: الإيمان بالله الواحد الأحد، الذي فطر النفوس على معرفته، وأرشد العقول إلى سبيله، وأراح القلوب في قربه.
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين.
وهكذا نصل إلى نهاية سلسلة “مع القرآن لفهم الحياة”. وقد حاولنا فيها أن نكتشف خريطة الإيمان داخل النفس البشرية، لنُدرك أن القرآن ليس كتاب شريعة ووعظ فقط، بل مرآة ناصعة للفطرة الإنسانية، ومنهج شامل لفهم الحياة بعقلٍ وقلبٍ وروح.
 آفاق فكرية بحث، معرفة، تبادل ثقافي
آفاق فكرية بحث، معرفة، تبادل ثقافي